
ينذر الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل الأنظمة القديمة وإعادة التفكير.
رغم شيوع ذكر الخضر في المؤلفات الإسلامية، وتأثير قصته على بعض المعتقدات والممارسات في الثقافات الإسلامية، فإنه لم يحظَ بالقدر الكافي من الدراسة والتأصيل النظري. يساهم كتاب “النبي الخضر: بين النص القرآني والسياقات الإسلامية” لعرفان عمر في معالجة هذه الفجوة، مستندًا في ذلك إلى دراسات مطولة سابقة للخضر أجراها باتريك فرانك وطلعت حلمان، مع التحقيق الدقيق والواسع في هذا النبي الغامض. يهدف عمر في هذا الكتاب إلى دراسة الخضر من إطار أوسع، والذي “يشمل التمثيلات النصية والأدبية، بالإضافة إلى المنظورات الرمزية والأسطورية… للكشف عن الروابط المتداخلة بين قصة الخضر والأساطير الأخرى التي تركز على شخصية المنقذ الحكيم”، “واستكشاف السمات المختلفة للخضر بصفته رسولًا إلهيًا مكلفًا بمساعدة المؤمنين والباحثين عن الحق والسلام بغض النظر عن الزمان أو المكان أو المنزلة أو الدين”. وقد أثمرت جهود عمر هذه عن صورة ثرية وواسعة لكنها دقيقة في تفاصيلها ومركبة وزاهية لقصة الخضر عبر التاريخ الإسلامي والمؤلفات الإسلامية.
الخضر هو الشخصية الغامضة المذكورة في سورة الكهف ضمن الحديث عن لقاء موسى بشخص روحاني لم يُسمَّ (الكهف: 60-82). لم يُذكر في السورة سوى أنه {عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا}، ورجّح المفسرون المتقدمون أن هذه الشخصية هي الخضر، واجتهدوا في تبيين مكانة عبد الله هذا -الذي بدا من القصة أنه يتلقى العلم من الله مباشرة- ضمن إطار علم النبوات ولا سيما في علاقته بموسى. لم يقتصر تناول شخصية الخضر على التفاسير المتقدمة فحسب، بل امتد ليشمل الخطاب والتصور الصوفي والفولكلور. صار الخضر من البداية رمزًا للمعرفة الحدسية وتسوية المراتب وإغاثة الملهوفين وحماية المسافرين ونضارة الطبيعة والمياه ورحمة الله، بيد أن العلماء والصوفيين والشعراء وعامة الناس -باختلاف السياق- أضافوا إلى هذه الموضوعات اختلافاتهم الخاصة في فهمهم لقدراته ونواياه ودلالته. يتجلى الخضر بصورة غامضة للمسلمين -بدءً من ابن العربي إلى عامة الناس كصياد في البنجاب- حيث يُفهَم على أنه يحمل معه بصائر ربانية وعناية إلهية (عبر الرحمة الإلهية). ومن خلال الدراسة المستقصية لقصة الخضر في مختلف المؤلفات والسياقات الإسلامية، قدّم عمر “نظرة عامة على إرث الخضر القرآني، والأدوار المتزايدة التي تقلّدها مع تداخل قصته بأساطير أخرى؛ كما أبرز تنوع التمثيلات الرمزية النابعة من الصفات الأساسية المنسوبة إليه”.
يحشد عمر مجموعة من المصادر لإثبات ودراسة تجذّر الخضر في المصادر النصية للإسلام، وهي القرآن والحديث وقصص الأنبياء والأدب الصوفي. يبحث الفصل الأول في مصادر القرآن والحديث التي “أوحت بقصة الخضر لمحاولة حكاية قصة رمزية عن موسى”. تروي القصة القرآنية سعيَ موسى للقاء الخضر والعثور عليه عند مجمع البحرين. وفي هذه القصة تتناقض أفعال الخضر ظاهريًا مع “المعايير الأخلاقية التي يتبعها موسى”. يشير عمر إلى أن هذه الأفعال تجعل الخضر رمزًا للمساعدة الإلهية للمستضعفين “والفجوة القائمة بين المعرفة الباطنية والظاهرية”، فالمعرفة الإلهية -كما نتعلم من لقاء موسى والخضر- قد تُتلقى في شكل “شريعة أو وحي” (كما كانت بالنسبة لموسى)، “أو معرفة صوفية حدسية” وحقيقة تتجاوز حدود الإدراك العقلي (كما أوتي الخضر).
يأتي اسم الخضر من الخُضرة، وقيل ذي العباءة البيضاء، وقد ورد في الحديث أنه “جلس على فروة بيضاء فاهتزت تحته خضراء”. يقول عمر “يوجد بعد ثقافي بين علماء السنة والصوفية، ويبدو أن الخضر قد لبى الحاجة الأعمق لرؤية الارتباط الحيوي بين العوالم الإلهية والإنسانية”.
وبعد النقاشات التمهيدية في الفصل الأول، يناقش الفصل الثاني اهتمامات المفسرين المتقدمين والمتصوفة المتأخرين فيما يتعلق بمكانة الخضر بصفته نبيًا، ثم شيخًا مرشدًا غائبًا فيما بعد. يفصّل عمر في نشأة هوية الخضر المزدوجة: نبي “وولي”، ويتوسع في الارتباطات الرمزية له بالتجدد والخصوبة والسمك والمياه وحماية المسافرين. صار الخضر رمزًا للخلود، وهذا يتوسع عند المتصوفة إلى “حالة وجودية” رمزية يتطلع إليها المؤمنون ذوو الميل الصوفي.
يركز الفصل الثالث على أهمية الخضر عند الصوفية، فقصته تتوافق مع تركيزهم على علاقة الشيخ المرشد بالمريد ومبدأ التلقين والمعرفة “والبصيرة الإلهية” التي يُعتقد أنه يمتلكها ويكشفها عند ظهوره للمؤمنين. كما يُعتقد أنه قطب روحي (أحد الأقطاب الأربعة) في علم الكونيات الصوفي، ويمثل “مبدأ التلقين” الذي يكون الشيخ بموجبه حاضرًا دائمًا لطلابه/ مريديه -وإن غاب بجسده- عبر الزمان والمكان (وهذا يرتبط أيضًا باعتقاد الصوفية بخلود الخضر، وهي مسألة شديدة التعقيد). حتى أن الطريقة الصوفية الأويسية في آسيا الوسطى تعد الخضر شيخَها المؤسس. ويقول بعض الصوفية إنهم قد تلقوا خرقة منه لاعتقادهم بخلوده وحضوره الدائم، وهذا يوضح ما يشير إليه عمر بقوله “نموذج الخضر” الذي يعبر عن العلاقة بين الشيخ والمريد.
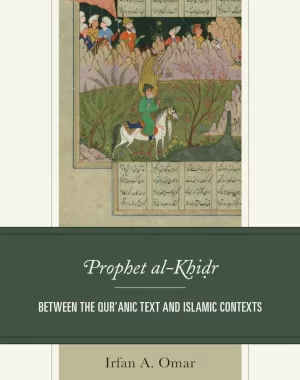
إن قصص الخضر والمقامات المنسوبة إليه والممارسات التعبدية المتعلقة به تتجلى في صميم التدين الشعبي في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط (لم يذكر عمر إفريقيا في فصل الفولكلور). وهذا هو موضوع الفصل الرابع من الكتاب، حيث يبحث عمر في طرق ارتباط القصة ودوافعها بروايات ما قبل الإسلام والأساطير الأخرى. تكشف مختارات من المظاهر الفلكلورية والثقافية لقصة الخضر أن مقامات الخضر قد أوجدت مجموعة من الأماكن المقدسة ذات الطابع المحلي، لكل منها قصة فريدة عن تجلياته. وقد وردتنا أمثلة لتمثيلات مرئية في أشكال مركبة تخلط بينه وبين شخصيات غير مسلمة، مثل القديس جورج، كما تبيَّن أن الخضر عند مسلمي الهند يحل محل التعبد العامي ذي التوجه الهندوسي. يقول عمر “يمكن أن يُعد الخضر جسرًا إسلاميًا بين الأفكار والقصص المنتشرة عبر الزمان والمكان. لقد صار رمزًا للإرث التعاوني الذي يمتد عبر القرون ويتجاوز الحدود الوطنية والثقافية والدينية”.
أما الفصل الأخير من الكتاب فيقدم معالجة آسرة ومقنعة لتفاعل الشاعر الهندي الباكستاني من القرن العشرين محمد إقبال مع شخصية الخضر في شعره. لقد شكلت “فلسفة العمل” القوية لدى إقبال نظرته للخضر، حيث رآه رمزًا للعمل والحركة والتجديد. وفي ظل عصره (جنوب آسيا الاستعماري قبل التقسيم) عبرت هذه الرمزية في شعره بصدق عن مفهومه اللاهوتي والوجودي لـ “الذات” (بالأردية: خودي)، والذي أكد على دور الإنسان في رحلة التعلم والعمل والسعي إلى القرب من الله دون الاتحاد به. كان شكلَي المعرفة المتجلية في قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف وإشارتها إلى مجمع البحرين -الشريعة والهيكل من جهة والمعرفة والتجاوز من جهة أخرى، أو الظاهر والباطن- وانتماء الخضر للمضطهد والمسافر والباحث عن الحق، كان كل هذا أرضًا خصبة للخيال الشعري لإقبال وقيادته بصفته مفكرًا دينيًا في فترة عصيبة على المسلمين في جنوب آسيا.
يعد كتاب عمر “النبي الخضر” إضافةً ثرية إلى الأدبيات المتعلقة بالخضر، ذلك بفضل نقاشاته النافذة والدقيقة وبحثه المتقن والشامل وحشده للمراجع وإضافته للحواشي والاستعراض المتكامل الذي يقدمه الكتاب لمورد ديني روحي عريق ومتعدد الجوانب، وهو قصة الخضر. الكتاب قصير إلى حد ما، حيث يقع في 139 صفحة إجمالًا، 30 صفحة منها للحواشي، و16 صفحة للمراجع والفهارس. إلا أنه مع ذلك يوضح أن قصة الخضر لها صدى عميق مع موضوعات وتساؤلات مهمة حول المعرفة وكيف يوصلها الإله إلى البشر. كما يثبت الكتاب أن قصة الخضر ما زالت حية، لأنها تقدم إمكانات لا حصر لها لتفسير الموضوعات المركزية في التدين الإسلامي بدءً من المعاني السامية إلى الأمور الدنيوية. بوجه عام، دراسة عمر الجذابة للغاية والدقيقة ستزيد القرّاء تقديرًا لقصة الخضر وتأثيرها في التراث الإسلامي، كما ستزوّدهم بنظرة أوسع على الموضوعات المركزية في الإسلام التي توضحها رواية الخضر ورمزيته -والأسئلة المحيطة بهما-.

ينذر الذكاء الاصطناعي بإعادة تشكيل الأنظمة القديمة وإعادة التفكير.
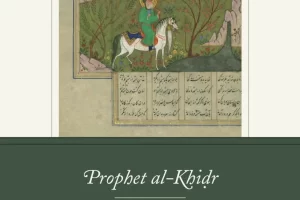
يهدف عمر في هذا الكتاب إلى دراسة الخضر من إطار أوسع.
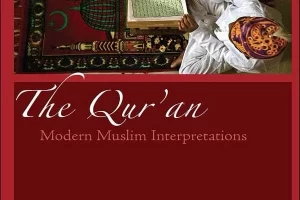
كتاب معاصر يستعرض التطورات الحديثة التي يشهدها العالم الإسلامي فيما يتعلق بالقرآن.